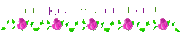
يعلق السهروردي شروط الخوض في التجربة الصوفية على تحقيق الحرية في أسمى معانيها ، قبل الاستعداد لتقبل العرفان ممثلا في الفيوضات الإلهية التي وعد بها االله عباده المتقين بحسب تأويله للآية الكريمة المتضمنة في المقبوس ، ولا يخلو الأمر على كل حال من رياضات ومجاهدات وتمثلات متقايسة مع مجازات التحلية والتخلية ، وغيرها من الممارسات الروحية التي تظل قبل كل اعتبار زاد المسافر ، وشغله ، وهمه ، ودأبه ، وديدنه ، حتى يصل إلى مرتبة العرفان التي وصف أطوارها الجنيد توصيفا بليغا بقوله في وصف العارف : "عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقه ناظر إليه بقلبه ، أخرقت قلبه أنوار هدايته وصفا شرابه من كأس وده ، تجلى له الجبار عن أستار غيبه ، فإن تكلم فباالله وإن سكت فمن االله وإن تحرك فإذن االله ، وإن سكن فمع االله ، فهو باالله والله ومع االله ومن االله وإلى االله " (32).
وضع الجنيد بين أيدينا ملامح الهوية الروحية التي تصيرها التجربة الصوفية الناضجة ، خصوصا عند أربابها الذين أغنوا التراث الروحي في الفكر الإسلامي من حيث أغنوا الأدب العربي بتراث ، على الرغم من الهامش الذي دفع إليه من الثقافة الرسمية ، ظل يمارس أشكالا مختلفة من الإغراء والتحدي على مر العصور ، شأنه شأن الآداب العالمية العظيمة التي لم تستنفذ مخزونها الجمالي والتأويلي على اختلاف المقاربات المتباعدة في الزمان وفي الأدوات النقدية .
إن التجربة الصوفية الواقعة في الخلفية المظللة لهذا الأدب هي التي حددته وميزته ، وأعطته خاصيته الاستثنائية من بين مختلف الألوان الأدبية والفنية التي أنتجها البشر ، في مختلف البيئات والثقافات ، ذلك أن الأدب الصوفي لا يصدر عن ممارسة فنية صرف ، بل عن ممارسة عاطفية ووجدانية لا سبيل إلى إسقاطها في أية دراسة تحترم الشرط العلمي في مقاربتها ، لأن اختزالها في بعدها اللغوي والأدائي يجردها أساسا من مادتها ولحمتها وسداها ، فالأبيات القليلة ، والمقطعات الصغيرة التي كتبها المتصوفة ، في لحظات الانخطاف التي أبان الجنيد عن جوانب منها في توصيفه السابق للعارف ، وفي لحظات الوجد الغالب ، والسكر العنيف المطوح باللب ، لا يتريث فيها أصحابها تريث أصحاب الصناعة ، لتقليب النظر في العبارة واستوائها ، أو في بلاغتها وفصاحتها ، بقدر ما يجهدون في القبض على البرق الخلب ، واللَمع المتقطعة وراء الخيال ، يقربون منها حينا ويبعدون أحايين كثيرة ، يتربصون بها ولا يكفون عن مراودتها ، حتى إذا برقت ولمعت ، شغلهم الكشف عن التحقيق ، واستغراق اللب بالسر عن الوعي باللباب والقشر بله عن الوعي بالنظم وما ينبغي له .
وهم في ما يعرض لهم من أحوال ، وما يملأهم من وجد ، وما يستغرقهم بالكلية في لحظات الكشف تلك التي يعودون منها بأطياف خيال ، ورعشات إحساس ، ومعلوم كالمجهول ، وعيان كالخبر ، يحدوهم الأمل في أن يكونوا على شيء ، وأنهم أدركوا المنازل وحطوا بالديار بعد طول السرى ، ولكن الريبة تستولي عليهم سريعا ، والسؤال المحير ، والإشفاق من استيلاء الوهم واختلاط أمشاج الرؤيا ، تدفعهم في الصحو المنبلج بعد محاق المحو ، إلى إعادة صياغة التجربة على ضوء تصنيفات السابقين من الراحلين إلى االله ، وتعريفات الأئمة في أبواب هذه النحلة ، وتفريعات أهل النظر من شيوخ الطائفة ، فيتخذون من مقولاتهم عناوين لتلك البوارق التي لاحت ، وأسامي لتلك التباريح ، وإشارات على تلك المنازلات ، لا يحسمون ، ولا يقطعون ، ولا يريحون ، ولا يرتاحون نظرا ولا تجريبا ، لأن المأمول خطير ، والمعالم ليس عليها دليل ، والمعشوق عبقري الدلال ، فلم يبق إلا القيل المحمول على ألف احتمال ، وإلا الإلغاز أغلب الوقت ، ليس بضرب اختيار ، وإنما نزولا عند مقتضى الاضطرار ، فلا تكاد اللغة تسع الحال ، ولا الإشارة تفي بالإدلال .
وعندما تجنح الأحوال هذا الجنوح ، وتنزع المشاعر هذا النزوع ، لاسيما في مضمار التجربة الصوفية التي مبتدأها ومنتهاها ما وراء الحس والخبر ، تنحرف الملفوظات صوب التعالق الحميم مع الفلسفة والفكر والنظر ، ويصبح التنكب عن هذه الوشائج إسقاطا سيئا لمكون جوهري في تركيبة الخطاب الصوفي الذي يزج بنا ، في هذا المقام ، في مبحث شديد الضيق والخصوصية بتصديه لبحث التعالق القائم بين الأدب والفلسفة ، الذي وقف بصدده رينيه ويليك متسائلا : "هل يغدو الشعر أفضل إذا كان فلسفيا بصورة أكبر ؟ وهل يمكن أن يحكم على الشعر بحسب قيمة الفلسفة التي يتبناها ؟ أم هل يمكن . أن يقاس بمعيار الأصالة الفلسفية أو بدرجة تعديله للفكر التقليدي؟"(33). تساؤلات لا تخلوا من تقرير ظاهرة مركوز ة في طبيعة الأدب التي تصدر من ذات يؤكد غويو مارلي بصددها بـ : "أن الصفة الأساسية التي يمتاز بها الشاعر هي في جوهرها الصفة التي يمتاز بها الفيلسوف "(34).
ولأن الفلسفة فكر ، وفي مضامين الأدب والشعر أفكار لا يضيرها الأصالة والابتذال ، و السطحية والعمق ، ظل الأدب أكثر استيعابا ومحاورة لمضامين الفلسفة ، يتمثلها ويجادلها ، وفي الأقل الأحوال يشير إلى تمظهراتها المختلفة في منتوجات العقل الأدب الصوفي وسيرورتها الإنسانية في الأفراد والجماعات ، وإذا كان الأدب تفكيرا بالصور كما يرى أرسطو ، فإنه موجود بالتالي في غالب الفلسفات بهذا القدر أو ذلك "(35)، وقد قيل : إن الفلسفة التي تخلو من العاطفة ولا تقيم نفسها في خضم العاطفة الإنسانية وألوانها وأشواقها وإحباطاتها فلسفة جافة ، وفي الوقت نفسه ، يصبح الشعر الذي لا يهدف إلى فكرة حقيقة أو رمزية يضيع صداه سريعا ويفر صداه من القلوب سريعا "(36) .على حد تعبير الدكتور خليل الهنداوي .
الواقع إن الأدب الذي استطاع أن يمزج في تضاعيفه ، بين الجمالي والفلسفي ، مزجا بارعا رفيقا ، محسوبة مقاديره بعناية ، هو وحده الذي استطاع أن يطاول الأذواق على اختلافها ، والأزمان على امتدادها ، فما أسرع ما يمتد الملل إلى النصوص التي تبيح نفسها في المباشرة الأولى ، ولا تمتد عميقا ولا عاليا ، بل امتدادا مسطحا لا التواءات فيه ، ولا تسويف ولا مماطلة ، وما أكثر ما تكلف النفوس بالغموض الحابل بالمعنى الموارب ، والوعد المتقارب ، والتمكين المبذول للطالب ، جاعلا من فعل مباشرة القراءة شراكة إبداعية ، ومساهمة لا تخلو من متعة المغامرة والاكتشاف ، وقهر عويص النص وتذليله ، والانتقال بفعل التلقي من السلبية الباردة إلى الإيجابية المتفاعلة ، دونما ادعاء بأن الغموض والإغراب محمودان لذاتهما دون اعتبار ، ولا توفرهما ، بالوفرة التي هما عليها في الشعر الصوفي خصوصا ، يعلو بهذا الأخير أو يهوي به إلا بمقدار ما بينهما من تناسب لا يلغي أحدهما الآخر بالكلية .
قال إبراهيم زكريا بهذا الصدد : "لو عدنا إلى تاريخ التفكير الميتافيزيقي لاستطعنا أن نقف على الصلة الوثيقة التي جمعت بين الحقيقة والشعر ، ومهما حاول الفيلسوف أن يحكم عقله في كل شيء ، بل مهما وقع في ظنه أن مذهبه الميتافيزيقي هو نظر عقلي خالص ، فإنه لابد من أن يجد نفسه محمولا على أجنحة الخيال إلى عالم يختلط فيه الحقيقة بالشعر ، ويمتزج فيه الواقع بالمثال " (37).هذا شأن الفلسفة في جانبها الميتافيزيقي المجرد، الحقيقة لا يمكنها الخلاص من الشعر ، ومن روح الشعر مهما حدا بها الزهو بالعقل المجرد إلى دعوى البراءة من رسيس الشعر الممتد عميقا في صلب الأشياء وحقيقتها ، مهما بدت لها أحيانا على خلاف ذلك ، ولا يخلو الشعر بدوره ، لاسيما الصوفي منه ، من اقتحام مجاهيل الميتافيزيقا وتجريداتها الرياضية المعجبة ، بل يمكن الجزم بلا خوف من غلط ، بأن الشعر الصوفي المصنف في القسم النظري من الخطاب الصوفي ، يمثل، لوحده، نمذجة متفردة لتداخل الفلسفي بالشعري، أو الشعري بالميتافيزيقي .
وعلى حد ما تساءل جان فال : "ماذا عسى أن تكون الميتافيزيقا ، وماذا عسى أن يكون الشعر ؟ إلا أننا نعلم على الأقل أن جوهر الشعر لابد أن يظل ميتافيزيقيا ، ومن الجائز أيضا أن يظل جوهر الميتافيزيقا شعريا ، أليست الميتافيزيقا هي شعر الفلاسفة ، كما أن الشعر هو ميتافيزيقيا أفضل ، والشاعر فيلسوفا لكي يصير شاعرا أفضل ؟". (38) . بهذا المعنى يرتكز الشعر في قلب المعادلة الفكرية برمتها ، وتصير للرؤيا الشعرية أفضلية الالتباس بالجوهري في الحياة ، من حيث التباسها بالشرط الإنساني القاسي ، وبحثه الدءوب عن المعنى الذي ارتقى إليه كل المراقي ، واستعان في بحثه اللحوح ذاك بكل ما أتاحته له إمكاناته البشرية التي تضؤل أحيانا حتى تصير في حكم العدم ، ويغذيها الشعر والخيال أحيانا حتى تلج غيابات المجهول والمستحيل .
الرؤيا الشعرية ، إذن ، هي البدء و المنتهى ، في الرؤى والأفكار والفلسفة و الميتافيزيقا ، وكل المعارف التي تتاخم الحلم الإنساني ، وتعضده في القبض على المعاني المغيبة ، ومستحيلات الأشياء ، ولا تعجز ، أحيانا ، في تضمين الشعر الذي تلبسه برؤى بعيدة ورسالات تحب أداءها ، وأغراض تشيعها ورسالات تبلغها، فتقع ضحية الالتزام الإيديولوجي الذي يزيل عنها براءة الرؤيا وعذوبة التأمل القريب الذي يتحلل بسهولة في جماليات الشعر وأدواته الإنشائية ، فلا يطغى أحدهما على الآخر ، متيحين للعملية الشعرية أن تستوي بتوازن حذر بين الطرفين . يؤكد روستر هاملتون بأن المسألة في نظره : "تعتمد على طبيعة الغايات البعيدة من جهة وعلى نوع الشعر من جهة أخرى ، ذلك أنه لن نستطيع أن ننكر أن تدخل بعض الغايات البعيدة في بعض أنواع الشعر قد يؤدي ، بل إنه كثيرا ما يؤدي ، إلى تقليل قيمته ، ولكن من الواضح أن هناك أنواعا أخرى من الشعر تعتمد قيمتها الشعرية بلا شك على اعتمادا مباشرا على الغايات البعيدة التي تغنى بها "(39).
4 - منطق الإشارة
لما كانت التجربة الصوفية ، قبل كل اعتبار ، تجربة روحية مدهشة بعمقها ، وتفردها ، والتباسها بما يقع خارج مجالات الإدراك العقلي المجرد ، ظل أربابها يؤكدون على أن الذوق هو مناط العرفان ، وصرحوا بالقول بأن من ذاق عرف ، وأن لا سبيل إلى الإحاطة بمعانيهم نظرا ولا فكرا ولا تلقينا ولا مدارسة ، لأن معارفهم لا تنال من الألواح وإنما من الأرواح ، ولا تنال من الأوراق وإنما بالأذواق ، فجعلوا الذوق الذي يريدون به التجربة في قلب عملية العرفان الشاقة ، وأحلوا الرمز مكان البوح ، والإشارة مكان العبارة ، فليس ثمة ما يعبر عنه لغير الملتبس بالتجربة ، ولا ما يباح به لغير المخترق بنفسه أسوار العرفان الشاهقة المنيفة . ولما لم يكن هناك معلوم يورد بألسنة العوام، اضطر القوم إلى التلويح بأذواقهم إشارة حتى قال قائلهم: وعني بالتلويح يفهم ذائق غني عن التصريح للمتعنت.
لا يخفى أن الإشارة لوحدها تكرس القطيعة التداولية في أكثر صورها وضوحا ، فقد جعلت الاستغلاق مطلوبا لذاته، والغموض ذريعة إنشائية مقصودة ، وعلقت التلقي بشرط متعذر يشبه المستحيل، فلا يتصور أن يخوض الناس تجربة التصوف الشاقة من أجل الظفر بفك إشارتهم البعيدة ، كما لا يتصور أن تشيع الإشارة في الناس إلى حد يصير تداول النص الصوفي بينهم شيئا مبذولا ابتذال كلام العوام ، بما يلغي غموضه العصي ، وامتيازه المحير، ومبرر تحديه للعقول واستنفارها، وأساس الرهبة والتقديس الذي ما انفك يثيره في الوسط الإسلامي على الرغم من النكير ، وانقطاع أسباب التداول ، واستغلاق نصوصه الجليلة عن أفهام أكثر الخلق .
لابد من التأكيد في هذا السياق على الفرق بين الرمز والإشارة، فقد أهاب المتصوفة بالرمز وجعلوه مدار أشعارهم واتخذوه ذريعة لإنشاء بدائع القصائد في الخمر والغزل ، وزاحموا أربابها في التراث العربي الزاخر بهذا اللون من القصيد ، وواقعوهم بالحافر ، وزاحموهم بالبلاغة، وتناصوا، وتصادوا معهم لغة ومعنى، حتى صح الشاهد من هذا على ذاك ، ومن ذلك على هذا ، وتداخل الأدبان في الغرضين تداخلا لا يميز بينهما من لم يحط بدقائق الأدبين ، وبالاستناد على القرائن الكامنة المتوصل إليها بغير قليل من التبصر ، لأن الرمز ، في النهاية ، الظفر بطي معناه ممكن ، والإحاطة بمراميه مبذولة ولو بالتأويل البعيد ، وهو ، كما عرفه السراج الطوسي : "معنى باطن مخزون تحت كلام ظتعر"(40) ، بخلاف الإشارة التي " هي ما يخفى عن المتكلم كشفه بالعبارة للطافة معناه "(41).
على ضوء هذا التعريف لوحده ، يمكن النظر إلى مأزقية التلقي التي أحدثها المتصوفة في الأداء الأدبي، منذ مرحلة مبكرة، بمنهج يضطلع ، قبل كل شيء ، بالبحث في التجربة الصوفية وأنساقها المعرفية ومفعولاتها الانفعالية والوجدانية ، قبل الانصراف إلى مباشرة الأدب الصوفي من موقع لغوي أو لساني أو سردي ، أو من أي موقع يبتدعه النقد في تحولاته السريعة . فالنص ، على ما يرى إيزر ، لا يمكن أن يكون إلا من خلال الوعي الذي يتلقاه، سواء في لحظة البث أو في لحظة القراءة ومسارها التاريخي (42).
يروي القشيري في رسالته بأن أبا علي الروذباري لما قرب أجله وكان رأسه في حجر أخته قال :
وحقك لا نظرت إلى سواك بعين مودة حتى أراكا
أراك معذبي بفتور لحـظ وبالخد المورد من جناكـا
ثم قال : يا فاطمة ، الأول ظاهر ، والثاني فيه إشكال (43).
لقد اضطلع الروذباري بدورين مختلفين ومتكاملين في نفس الوقت ، بحسب ما يقرر الخطاب النقدي المعاصر في أكثر من منهج ، دور التلقي ودور الإيداع ، ولا ينفك المؤلفون على اختلاف مجالات إبداعهم يقومون بتقمص شخصية القارئ الفعال الذي يملأ فراغات النصوص ويتأول مشكلاتها قبل أن تخرج من يد صاحبها نهائيا إلى متلقين يتفاوتون في مواقعهم من النصوص بحسب كفاءاتهم المنهجية وخلفياتهم المعرفية ، وعلى هذا الأساس أبدى الروذباري ما يشبه (الورع) الديني بإزاء البيت الثاني الذي تلقاه في حالة تختلف بالكلية عن الحالة الأولى ، حالة يطلق عليها المتصوفة مصطلح الصحو تارة والبقاء تارة أخرى ، ولا يجيء الصحو إلا بعد محو ، كما لا يجيء بقاء إلا بعد فناء.
هاتان الحالتان اللتان تنسب إليهما جل شطحات الصوفية التي يخرجون فيها عن مقتضى (الورع) الفقهي والعقلي ، ويشفقون من تبعات التصريح بالعبارة ، ويكتفون بالتلويح والإشارة . وعند التأمل نجد الروذباري قد أعاد قراءة البيتين على ضوء مقتضيات التصوف السني الذي ما انفك ، منذ عهد الجنيد البغدادي ، يؤطر تلويحات المتصوفة وشطحام إلا في القليل النادر ، فقد ألزم القوم بحجة الشريعة في قيلهم وفعلهم ، وأناط بمقتضياا كل (دعاويهم) الصادمة للمستقر من مقولات التوحيد و قواعد الشريعة ، فكان بحق أول من لطف من الصدامية التي أحدثها المتقدمون عليه بين أفق التصو ف وأفق الشريعة مأزمين وضع التلقي إلى أبعد الحدود .
وعلى هذا الأساس استساغ الروذباري ( دعواه) المتضمنة لما يشبه العهد المقطوع بأن لا يتعلق قلبه بشيء سوى الحق جل و علا . وقطع العلائق كما معروف شرط في السلوك الصوفي ، ومنزل من منازل السائرين ، ومدرج في سلم المترقين ، فلا يتصور أن تسافر الأرواح ولا أن تعرج وهي موثقة بأغلال العالم الأدنى . فالمعنى بهذا الاعتبار لا شطح فيه ولا دعوى ، بيد أنه سرعان ما يصبح كذلك في البيت الثاني ، حيث ينصرف القول إلى شكوى غزلة ، تنسب للحبيب خدودا موردة وألحاظا (مريضة) فاتكة نعاوتم ، ، ودلالا ، ودلعا كدلع الغواني ، يبدو ساعة الصحو إشارة إشكالية ملتبسة بمحاذير كثيرة ، ومتصلة بدعاوى لا يسيغها الورع ، وشطحا لا يحيط بوجوهه الروذباري نفسه ، الأمر الذي جعله يصرح بما في البيت من إشكال .
نخلص من هذا إلى نتيجة مهمة في هذا السياق ، وهي أن الإشارة تستغلق على أربابها أنفسهم ، وتستعجم على مورديها وصانعيها غالبا ، حتى اضطر البعض منهم إلى تكلف شرحها بما يناسب أفق المتلقين المؤطر وفق قواعد العقائد الشرعية والمذاهب الفقهية ، على نحو ما صنع ابن عربي مع كثير من أشعاره المنظومة تلويحا وإشارة .
ولا يخلو الغموض المكتنف بالإشارة الصوفية من أحد سببين ، أولهما : طبيعة التجربة الصوفية نفسها ، التي دت إلى ألطف المسائل وأبعد الغايات الإنسانية كلها ، فقد نصبت الذات الإلهية مطلبها ومبتغاها ورائدها ، ومنطق وجودها أصلا وتفصيلا لا ، تنشد إلا إياه ، ولا تقف عند رسم ، ولا كون ، ولا مطلع ، ولا لائح سواها ، ولا تطلب معرفة من عقل ، ولا نظر ، ولا فكر، خارج ذاتها المنصرفة أبدا إلى إجلاء باطنها وصقله ، وإعداده لانطباع الفيوضات الإلهية والمعارف اللدنية التي تلوح كما تلوح البروق حينا بعد حين ، تملأ القلوب بالمعاني الرائقة ، والمعارف اللطيفة التي لا تحوطها العبارة لما في العبارة من تناهي ، وتقرب الإشارة من حماها لما في الإشارة من عدم التناهي.
فالإشارة الصوفية ، بهذا المعنى، فكر ومعرفة وعلم، ولكنها علم مخصوص ، ومعرفة عزيزة مصروفة إلى طائفة موصوفة بالخاصة وخاصة الخاصة ، وتلكم هي السبب الثاني من أسباب غموض الإشارة واعتياصها على الأفهام ، فقد لج بالقوم الحرص على معانيهم أن تتداولها العوام، وعلى علومهم أن تتبذلها الأفهام، فاصطنعوا لها اصطلاحات تدور بينهم وحدهم ، ضنا بها على غير أهل الخصوص حينا و ، دفعا لشنيع التهم عنهم أحيانا كثيرة .
يروي الكلاباذي عن أبي العباس بن عطاء حين قال له بعض المتكلمين : "ما بالكم أيها المتصوفة قد اشتققتم ألفاظا أغربتم بها على السامعين وخرجتم على اللسان المعتاد ؟ هل هذا إلا طلب للتمويه ، أو تستر لعوار المذهب ؟ فقال أبو العباس : ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه لعزته علينا ، كيلا يشردها غير طائفتنا ثم اندفع يقول :
أحســـــن مـا أظهره ونظهــره بادئ حـــــق القلوب شعــره
يخبــرني عني وعنه أخبــــره أكسوه مــن رونقه ما يستـره
عن جاهل لا يستطيع ينشـــره يفســـــد معناه إذا ما يعــبره
فلا يطبق اللفظ بل لا يعشـره ثم يـــوافي غيـــــره فيخبره
فيظهـر الجهـل وتبدو زهـره ويـــدرس العلم ويعفو أثــره (44)
أجمل ابن عطاء في هذه الأبيات موقف المتصوفة من العوام الذين ينسبونهم إلى الجهل تارة ، وإلى الوقوف مع الظواهر والرسوم تارة أخرى ، وهم يعنون في الحقيقة كل من لم ينتسب إلى الصوفية ولم يخض غمارها ، فتعذر عليه الذوق الذي جعلوه شرطا في التلقي ، ويعنون به الانفعال والفهم والإحاطة بمضامين الإشارة ، وما يغني صاحبه عن التصريح ، ويرفعه فوق مقتضيات العبارة ، ولا يتيسر ذلك إلا لمن جرب وذاق ، ليس يهم كونه من أهل البدايات مادام لا يخلو من مشاركة وجدانية ، ومن معرفة حاصلة بالقرب من فحوى تلك المعاني اللطيفة الراقية دون الإحاطة بمنتهاها ، فالذوق الصوفي نفسه منازل ومقامات يتفاوت فيها أربابها تفاوتهم في الصدق والهمة ، والعرفان الحاصل بالفتح الإلهي .
هذه المعاني وغيرها، جعلت المتصوفة يبررون مصطلحاتهم التي استحدثوها وأداروها بينهم بما عهدوه في اصطناع كل فرقة لعباراتها واصطلاحاتها الخاصة بها ، على النحو الذي بسط فيه القشيري القول في رسالته ، حيث قال : "إن لكل طائفة من العلماء ألفاظا يستعملونها انفردوا بها عن سواهم وتواطئوا عليها لأغراض لهم فيها، من تقريب الفهم على المخاطبين بها أو تسهيل على أهل تلك الصفة في الوقوف على معانيهم بإطلاقها ، وهذه الطائفة يستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم والإخفاء والستر على من باينهم في طريقهم لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب ، غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها ، إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع التكلف ، أو مجلوبة بضرب التصرف ، بل هي معان أودعها االله قلوب قوم واستخلص لحقائقها أسرار قوم "(45).
إن تلك المعاني التي أودعها االله قلوب أولئك القوم المصطفين ، لا تخلوا بدورها من خصوصية تجعل الكتم والاستسرار ضرورة لا اختيار معها ، مثلما تجعل البوح مغامرة مخفوفة بالمخاطر ، لأن التجربة الصوفية ، من حيث التعريف ، تجربة وجدانية منسوب جميع مضامينها إلى الحدس الذي لا يقوم عليه الدليل والبرهان ، وما أسرع ما يبادر الناس إلى الإنكار ، وما أيسر ما يؤدي الإنكار إلى التنكيل بالخارجين على المرسوم من حدود الشريعة في التاريخ الإسلامي العريض ، وما أكثر ما لقي بعض المتصوفة المستهترين من العرب والفرس والأتراك حتفهم جراء خروجهم على الاستسرار وبوحهم بشيء من أسرار العرفان ، على حد تعبير نيكولسون .
من أجل ذلك وجدنا ابن عربي يعبر بامتنان عميق عن فضل الرموز والإشارات على العارفين ، فلولاهما لهلك أكثرهم ، ولولاهما لما قامت لهم حجة ولا أدركتهم سعادة ، قال :
ألا إن الرموز دليـل صـدق على المعنى المغيب في الفـؤاد
وإن العالميـــن لـه رموز وألغاز ليدعـــــــــي بالعبـــــــاد
ولولا اللغو كان القول كفــــرا وأدى العـــــالمين إلى العناد
فهم بالرمز قد حسبـوا فقالوا بإهــــــراق الدمــاء وبالفســاد
فكيف بنا لـو أن الأمر يبدو بلا ستـر يكون لــه استـادي
لقام بنا الشقاء هنا يقينــــا وعنــد البعث في يوم التنــاد
ولكــن الغفـور أقام ستـرا ليسعدنا على رغم الأعـادي
فالرمز البعيد ، إذن ، والإشارة اللطيفة ، كلاهما أدوات فنية وعرفانية أهاب بها المتصوفة قصدا حينا ، ودون قصد أغلب الأحيان ، من أجل التعبير عن المعاني المغيبة في الفؤاد التي غالبا ما تصطدم مع ظاهر الشريعة ، ومع ما توضع عليه الفقهاء والمحدثون إقامة لحكمة التشريع قبل أي اعتبار آخر .
من هنا اضطر المتصوفة ، منذ مبتدئ أمرهم ، إلى التفريق بين كيانين معرفين رئيسين : الشريعة من جهة ، والحقيقة من جهة أخرى ، الظاهر والباطن ، الخاصة والعامة ، وغيرها من التقاطبات القائمة على أساس العرفان ومجال التجربة ، فإذا كان شأن الشريعة هو الحفاظ على استمرارية الخلافة البشرية في الأرض ، من حيث تنظيم العلاقة بين الناس أفقيا ، ومع رب الناس عموديا ، فإن المتصوفة قد وجدوا أنفسهم ، منذ بدايات تجاربهم الروحية المنهكة ، بإزاء معارف لا يقوم عليها ، بالضرورة ، شيء من أسباب استمرارية الخلافة البشرية ، بقدر ما تقوم عليها الحقيقة الفردية المتعالية عن الجماعة ، ومن ثم بدت الحاجة إلى التفريق بين الحقيقة التي لا يطيق مضامينها سوى الخواص الذين لا ينبغي النظر إلى منازلاتهم بمنظار الشريعة ولا بمقاييس العموم بأي حال من الأحوال ، وبين مقتضيات الشريعة القائمة على العموم أصلا وتفصيلا .
لقد كان هذا التفريق إيذانا بإطلاق الحرية الفكرية والروحية ، وتخلصا ذكيا من الضرورات التي تقوم عليها حياة العوام ، وتبريرا منطقيا لما يتعاطاه الخواص روحا ، وفكرا ، وكتابة ، ما دام مصروفا عن الحياة العامة إلى الخاصة ، ومن قوام الجماعة إلى حيز الفردية الخاص ، بما أمكن الذوات الخاصة ، وآحاد الممتازين من النوابغ ، أن يتبادلوا المعارف التي حصلوا عليها إشارة ورمزا ، حصرا للمعرفة من جهة ، وقياما بحق الاستسرار من جهة أخرى . قال ابن عجيبة في شرحه للحكم العطائية : "فإذا انفرد القلب باالله وتخلص مما سواه فهم دقائق التوحيد وغوامضه التي لا يمكن التعبير عنها وإنما هي رموز وإشارت لا يفهمها إلا أهلها ولا تفشى إلا لهم ، وقيل من أفشى شيئا من أسرارها مع غير أهلها فقد أباح دمه وتعرض لقتل نفسه كما قال أبو مدين رضي االله عنه :
وفي السر أسرار دقاق لطيفة تراق دمانا جهرة لو بها بحـنا (48)
لا غرو بعد ذلك أن يستغلق النص الصوفي وأن يمعن في الغموض ، وأن يطرح ، قديما على الأقل ، على هامش المعرفة الرسمية العالمة ، وأن يحدث في التداول العام تلك القطيعة التي لم تفلح تعريفات اللاحقين من المتصوفة ، ولا شروحهم ، من أن تردم الهوة السحيقة بين خصوصية النص الصوفي ، وعمومية (الاستهلاك) العام للأدب بوصفه منتجا قابلا لتحديدات السوسيولوجيا والاقتصاد ونظريات القراءة .
5 - على سبيل الخاتمة
الواقع إن مناهج النقد ، على اختلاف أدواتها ، وبغض النظر عن الوتيرة السريعة في تقلب منطلقاتها وفرضياتها ، تمدنا الحين بعد الحين بأدوات فعالة في استقراء النصوص ، وتحدد لنا مواطن الضعف من كياناتها القابلة للاختراق ، وزوايا الرؤية الفعالة ،وطرائق الهجوم القادرة على فتح مغالق النصوص وانتهاب مكنونتها وذخائرها ، بيد أنها لا تقدر ، بأي حال من الأحوال ، على تغيير الطبيعة الجوهرية لتلك النصوص ، ولا إخراجها من أحيازها الذاتية المخصوصة إلى أخرى ليست من صميم وجودها . والنص الصوفي نص متفرد في بابه ولغته وغرضه ، لا يخرج عن طبيعته تلك إلى حيز النصوص الأدبية المحكومة بتداولية الأدب مهما أطلقنا على شؤونه إطلاقات الأدب المعروفة ، ومهما ألبسته نظريات النقد أسامي تشركه في الآخر ، وتدخله في فضائه ، وتقاربه على أنه تمظهر أدبي يخضع لمقتضيات الفنون اللغوية ، ويستجيب بحكم مادة الأساس لما تستجيب له فنون القول ، وذلك لسبب جوهري أطلق عليه نحاتنا الأول اسم الوضع الذي يعنون به القصد الابتدائي المتحكم في نية المتكلم ، حتى إنهم أخرجوا كلام النائم من حيز (الكلام) لغياب النية والقصد في فعل التلفظ .
أما الأدب الصوفي ، وما اصطلح عليه كذلك ، للدلالة على ما أنتجه المتصوفة في المنظوم والمنثور ، لا يريدون به سوى تحقيق فعل الكلام في أسمى صوره ، من خلال التقاط الحقيقة وقولها بإخلاص إلهي ، ونقل تجارب العرفان وليس صنائع البلاغة والبيان ، فجاءوا به عفوا لترجمة تباريح الشوق ، والقرب ، وطلائع الفتح الروحي الذي لا تطيقه العبارة إلا لماما ، ولا بواطئ مألوفات التوقع والاستقبال إلا نادرا ، فاحدث القطيعة ، وتوارى إلى الهامش ، و اعتاص إلا عن باحث جاد يموضعه في سياقه الصحيح من التجربة الأدبية متجاوزا حدود المقاربات المبتسرة بسوء الإلمام بمقولات القوم وخلفياتهم المعرفية .
من هنا جاء سوء الفهم القديم والحديث للأدب الصوفي ، أما قديما فقد أوخذ فقهيا وشرعيا على نحو ما أسلفنا الإشارة ، وأما حديثا فقد راودته بعض الدراسات بممكنات الخطاب النقدي المعاصر ، ومقولاته المحفزة ، وأدواته اللسانية واللغوية الفعالة ، وصنفته ممارسة شعرية تخييلية يجري عليها ما يجري على سواها من فنون القول والتخييل ، وأغفلت الطبيعة العميقة للقيل الصوفي ، ومضامينه العرفانية التي لا يجيء إلا ليشير إليها من حيث يغمض ، نزولا عن مقتضى خصوصية التجربة والاعتقاد . أما الانزلاق النقدي على سطح اللغة ومعمار النصوص ، فلا نعتقد بأنه قادر على استيفاء حقوق الأدب الصوفي المنصرف من حيث التعريف إلى مواطأة الحق والمطلق وكنه الوجود .
الأدب الصوفي ، في نهاية المطاف ، وعلى حد تعبير زكي مبارك ، هو الأنشودة الباقية يوم تفنى الأناشيد . ليس إنجازا منصرفا للإنشاء الأدبي فيطلب طلاب الأدب ويقرأ قراءته ، ولكنه حقائق عرفانية متعالية تنقطع الأماني دونها أو تكاد .

